الداعية الإيجابي
احتدم الصراع، وأمعن مَن كان يُجاهر بالعَدَاء في عدائه،
وأسفر من كان يسِرُّ به عن وجهه القبيح، وأحاطت أمتَنا الروابي،
على كلٍّ منها رامٍ بسهم مسموم، وألغامُ الغدر والخيانة تناثرت
في مواطئ الأقدام.
فمَن يحسم هذا الصراعَ لصالح الأمة المكْلُومة؟
هل سيحسمه ذلك الثقةُ العاجز، الذي استعاذ منه
الفاروقُ عمر في قوله:
"اللهم إني أعوذ بك من جلد الكافر وعجز الثقة"؟!
هل سيحسمه مَن تبلَّد عنده حِسُّ النضال وانزوى بأمانته؟!
هل سيحسمه ذلك الذي يتحرك بالقصور الذاتي
وقد نَضب وَقودُه الدعَوي؟!
كلا!
إن رجلَ هذه المهمة إنما هو الإيجابي، صاحب المبادرة الذاتية،
ونفسية التملص من الحصار والقيود، نفسية التمرد على الواقع الماجن،
يأبى الخضوع للقيود، يرفض حياة العبيد، إنه الداعية الإيجابي بكل
ما تحمله الإيجابية من معانٍ سامقة تستحق التَّجْوال في أفلاكها:
الداعية الإيجابي صاحب مبادرة ذاتية:
لا يَنتظر التكليف، يُطلق لنفسه أشرعتها البيضاء،
ويسبح في المساحات المتاحة في إطار الانضباط بالشرع،
تدفعه طاقة في داخله، تولَّدت مِن شعوره بالقضية، تلك الذاتية
التي علّمنا إياها هدهدُ سليمان الذي لم ينتظر تكليفًا من أحد حتى
يتحرك لدين الله، فدل علي جريمة الشرك، فكان سببًا في
قمعه وإسلام القوم.
هذه الذاتية هي التي حركت الشابَّ المجاهد "حسن أولو بادلي"
ورفاقَه في حصار القسطنطينية إلى اقتحام الموت.
وتبدأ قصتهم معنا من يوم الاثنين، التاسع عشر من جمادى
الأولى 857 هجريًّا، وقد جلسوا أثناء فترة الحصار يتجاذبون
أطراف الحديث وهم يتناولون طعام الإفطار بعد صيامهم.
وكان حديثهم حول قضيتهم العظيمة فتح القسطنطينية،
وكيف أنها استعصت على الفتح بسبب إحكام التحصينات على
أسوارها، رغم الثغرات التي أحدثتها مدافع السلطان محمد الفاتح،
وتاقت أنفسهم لنيل إحدى الحسْنيين، فتواعدوا على أن يكون
هدفُهم هو ثغرةً عند باب الجهة الشمالية.
ولما أذن المؤذن لصلاة الفجر، اصطف الجند بين يدي الله،
ثم انطلقوا إلى النِّزال والقتال، وتساقط الشهداء واشتد البأس،
وفي هذه الأثناء كان حسَنٌ ورفاقه يتقدمون نحو الثغرة التي حدَّدوها،
وانهمرت عليهم السِّهام وقدور الزيت المغلي، لكنهم تمكَّنوا من
ولوج الثغرة، وقاتلوا داخل أسوار القسطنطينية بقوة وبَسالَة،
حتى تمكَّنوا من فتح أحد أبواب القسطنطينية.
واندفع جند الإسلام، بينما كان حسن ورفاقه يسقطون
شهداء - إن شاء الله - بعدما نالوا شرف أولوية دخول القسطنطينية،
وكانوا سببًا في فتحها، دون أن ينتظروا تكليفًا، ينطلقون بدافع ذاتي،
بروح المبادرة.
الداعية الإيجابي هو الذي
يركِّز على دائرة نفوذه أكثر من دائرة اهتماماته :
فلكل منا دائرتان: دائرة نفوذ،
وهي كل ما يقع تحت سيطرتنا المباشرة، والمساحات التي نملكها،
ودائرة اهتمام، وهي كل ما نهتم به، لكنه لا يقع تحت سيطرتنا المباشرة.
والداعية الإيجابي هو الذي يركز على دائرة نفوذه، ويستغل كل طاقاته
وإمكانياته للتعامل معها؛ حتى يصل من خلالها إلى دائرة اهتماماته.
وننظر في هذا المقام إلى أبي بصير - رضي الله عنه - الذي ردَّه النبي
- صلَّى الله عليه وسلَّم - التزامًا ببنود معاهدة الحديبية، وفي الطريق يحتال
على مقتادَيْه، فيقتل أحدهما، ويفر منه الآخر، فيأتي رسولَ الله،
فيرده ثانيةً، فماذا فعل أبو بصير؟
لقد ترك الاهتمام بما لا يملكه، واهتم وانشغل بما يستطيعه ويقع
في دائرة نفوذه، فعسكر في سيف البحر، وانضم إليه بعضُ مَن سمع
به مِن المؤمنين، وكانوا يُغِيرون على قوافل المشركين، حتى اضْطُرَّ
المشركون إلى أن يطلبوا من النبي أخذهم حتى يأمنوا شرهم.
الداعية الإيجابي يحرص على سهمه في الصفقات الرابحة:
لا يقعد عن ذلك حتى ولو لم يكن له إلا تكثير السواد؛
قال أنس بن مالك: "رأيت يوم القادسية عبدالله بن أم مكتوم الأعمى،
وعليه دِرْع يجر أطرافها، وبيده راية سوداء، فقيل له:
أليس قد أنزل الله عُذْرَك؟
قال: بلى، ولكني أكثِّر سَوَادَ المسلمين بنفسي".
مع أنه - رضي الله عنه - قد طَلب أن تكُون معه الرايةُ؛ لأنه أعمى،
لا يفرُّ وحده، ويَضرب بالسيف يمينًا وشمالاً، وهو عساه يصيب كافرًا،
ومات - نحسبه - شهيدًا، والله حسيبه في ذلك الموقف، مُقْبِلاً غير مُدْبِر.
بل إن ذلك الداعيةَ إيجابيٌّ حتى في أحزانه وهمومه،
يخرج علي بن الفتح - رحمه الله - يوم عيد الأضحى، فيرى الناسَ يضحون،
وهو فقير لا دينارَ له، فانتحى جانبًا وقال: "يا رب، وأنا تقرَّبْتُ إليك بأحزاني".
وأما سيد التابعين أويسٌ القرني فيُناجي ربَّه، يشكو إليه عجْزَه
عن إعانة إخوانه، الذين أعياهم الجوع والبرد، فيطلق عباراتٍ رقراقةً:
"اللهم إني اعتذر إليك اليومَ مِن كَبِد جائعة وبدَنٍ عارٍ، فإنه ليس في بيتي
من الطعام إلا ما في بطني، وليس شيءٌ من الدنيا إلا ما على ظهري".
الداعية الإيجابي صاحب مشروع ورؤية واضحة،
يقتنع بها، ويتفاعل معها:
يُخرِج أفكارَه مِن حيِّزها الضَّيِّق إلى مجال الحياة الرَّحْب،
يَفتح الوسائل بإرادة صلبة، وعزيمة قوية، حتى يصل إلى أهدافه.
إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا: مَنْ فَتًى؟ خِلْتُ أَنَّنِي *** عُنِيتُ، فَلَمْ أَكْسُلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ
بهذا البيت أجاب الشيخ حسن البنَّا - عندما كان تلميذًا - على معلِّمه لمَّا سأله:
أيَّ أبيات الشعر يفضِّل؟ فعلق أستاذه على ذلك "سيكون لك شأن عظيم يا بني".
فكتب التلميذ النجيب في موضوع الإنشاء وكان تحت عنوان
(اشرح آمالك بعد إتمام دراستك، وبيِّن الوسائل التي تعدها لتحقيقها)،:
"وأعتقد أنَّ خير النفوس تلك النفوس الطيبة،
التي ترى سعادتها في سعادة الناس وإرشادهم، وتَعُدُّ التضحية
في سبيل الإصلاح العام رِبْحًا وغنيمةً، والجهادَ في الحق والهداية
- على وُعُورة طريقها - راحةً ولذَّةً، وأعتقد أنه العمل الذي يتمتع
بنتائجه العامل وغيره، وأعتقد أن أجلَّ غاية التي يرمي الإنسان
إليها، وأعظم ربح يربحه: أن يَحُوز رضا الله".
وكان له أمَلان بعد إتمام الدراسة، قال: خاص: إسعاد أسرتي وقَرابتي،
وعامٌّ: أن أكون مُرْشِدًا معلِّمًا إذا قَضيت في تعليم الأبناء سحابة النهار،
ومعظمَ العام قضيتُ ليلي في تعليم الآباء هدَفَ دينهم.
وأعددْتُ لتحقيق الأول معرفةً بالجميل، وتقديرًا للإحسان،
ولتحقيق الثاني الثباتَ والتضحيةَ".
الداعية الإيجابي تحرَّر مِن أوهام الانفصال بين الدنيا والآخرة،
ومِن السقوط فريسةً لهذه الأوهام:
علِم أن الله لم يَذُمَّ الدنيا مجردةً، وإنما ذمها مقارَنةً بنعيم الآخرة،
وذمها لمن رضي بها حظًّا، وذمها لتنبيه الغافلين، علم أن الإنسان مستخلف
فيها ليعبد الله ويعمر الأرض، وأن الله تعالى عندما يقول:
﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾ [آل عمران : 14]
فإنه يذكِّر بما هو خير منها، لا لبيان قبحها في نفسها.
علم أن الدنيا قنطرةٌ للآخرة، وأنَّ عليه إصلاحَ هذه القنطرةِ؛
لضمان سلامة العبور إلى الآخرة، علم أن الدنيا والآخرة طريق واحد
أوله في الدنيا، وينتهي في الجنة، فغَرَس الفسيلة.
هذا التحرر جعله ينعم بسعة الإسلام، فخرج مِن ضِيق التكَلُّف
والتنطُّع ومعاني الزهد الزائفة، إلى وسَطية الإسلام والزهد الحقيقي،
ولم يضيِّق على الآخرين، وسار بخطوات متَّزنة رشيدة، ووسطية
بين التجرد الروحي والارتكاس المادي.
الداعية الإيجابي مستعْلٍ بإيمانه:
شعاره:
﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾
[آل عمران : 139]،
مُستعْلٍ على القِيَم والموازين الرديئة، مستعلٍ على شهواته ورغباته،
يوجهها حيثما أراد، مستعلٍ على اللصوق بالأرض.
كيف لا وهو يأوي إلى ركن شديد، يتلقَّى مِن الله، ويتجرد لله،
ويَجول الأرض سعْيًا في سبيل الله، فلِمَ لا يستعلي بإيمانه؟!
لذلك فاستعلاؤه يمسك بحجزه عن السقوط في وحل المراهنات
والتنازلات وذبح المبادئ.
يأتي مسيلمة الكذاب يَعرض على النبيِّ صلى الله عليه وسلم
اقتسامَ الشرف؛ راجيًا أن يحظى بأنصاف الحلول، وكان بيد النبي
جريدةُ سعف يقول له:
(لو سألْتَني هذه القطعةَ ما أعطيتُكَها، ولن أتعدَّى أمْرَ الله فيك).
ومِن مدرسة الاستعلاء الإيماني خرج رِبْعِيُّ بنُ عامرٍ
ليدخل بفرسه على بساط كسرى، ويخرق النمارق والفرش،
وهو سائر بحربته جاهرًا بحقيقة الابتعاث.
ومنها خرج عبدالله بن حُذَافة السهميُّ الذي أَعْيا باستعلائه عدوَّه،
وأرغمه على إطلاق سراح أسرى المسلمين بقبلةٍ لا وزن لها على
رأس الملك، ولولا ما على آثارها من مصلحة للمسلمين، ما كان
ليفعلها ابنُ حذافة، الذي وقف أمام الموت بشموخ واستعلاء.
الداعية الإيجابي تربِّيه الجراحُ، وتشدُّ عودَه الصدمات:
تلك الجراح المربِّيَة التي عبَّر عنها أحدُ الدعاة بقوله:
"هي الخلفية التي تسند التطور الشخصي للداعية، والتطور الجماعي؛
لأن الألَمَ يعصر القلب، فيحركه نحو طلب الأمن والهدوء، ويحفِّز العقل
للتفتيش عن منطقه بدقَّةِ وصْف، وأسباب تعليل، وكل ذلك نضوج،
لكنه يحتاج ثمنًا من الحرقة واللذعات والصبر المُرِّ.
الداعية الإيجابي يرفع شعارًا له (نفس لهوها التعب):
نعَم، إنه النَّصَب والتعب، وبرد شذرات العرق على الجبين
في سبيل الله، هي لذَّته، يمكث صلاح الدين أسبوعين على فرسه،
يَعُدُّ كتائب الإيمان لمعركة حطين، فألَحُّوا عليه أن ينْزل ويستريح،
إذا به يشعر بالتعب على فراشه، فتحِنُّ نفسُه وتشتاق إلى لهوها،
فيَنشُد ذلك بالنصَب على صهوة جهاده في سبيل الله.
وقيل لأحد الإيجابيين: ألا ترتاح؟ فقال: راحتَها أريد.
الداعية الإيجابي لا تفارقه تلك الفضيلة، بل هي معه إلى قبره:
وأختم بإيجابية محمد الفاتح في ساعة احتضاره؛ إذ يقول لولده:
"هاأنذا أموت، ولكني غير آسف؛ لأني تاركٌ خلَفًا مثلك، كن عادلاً
صالحًا رحيمًا، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على
نشر الدين الإسلامي، فإن هذا واجبُ الملوك على الأرض، قدِّم الاهتمامَ
بأمر الدين على كل شيء، ولا تَفْتُر في المواظبة عليه، ولا تستخدم
الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين، ولا يجتنبون الكبائر،
وينغمسون في الفحش، وجانِبِ البِدَعَ المفسِدَةَ،
وباعِد الذين يحرضونك عليها.
وسِّع رقعة البلاد بالجهاد، واحرس أموال بيت المال
مِن أن تتبدد، إياك أن تَمُدَّ يدَكَ إلى مالِ أحد مِن رعيتك إلا بحق الإسلام،
واضمن للمُعْوِزين قُوتَهم، وابْذُلْ إكرامَك للمستحقين.
وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة؛
فعَظِّمِ جانِبَهم، وشجِّعْهم، وإذا سمعْتَ بأحد منهم في بلد آخر،
فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال.
حَذَارِ حذار، لا يغرنَّك المال ولا الجند،
وإياك أن تُبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تَميل
إلى أي عمل يُخالِفُ أحكامَ الشريعة؛ فإن الدِّين غايتُنا،
والهداية منهجنا، وبذاك انتصرنا".
وأخيرًا:
فلئن كانت هذه أحلامَنا لداعية الإسلام، فإنها ليست
ببعيدة المنال، والداعية يحتاج - أكثر ما يحتاج - إلى تعميق
صلته بربه، فيتوهج الإيمان في قلبه، وتُوهب له طاقةٌ تسري
في همته، تدعَمُها نظرة متفحصة في واقع مرير طوَّق
حياةَ المسلمين، والله المستعان وعليه التكلان.
منقول








 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
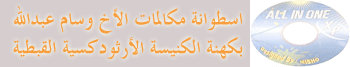







المفضلات