هل أنت راض عن الله ؟
لماذا لا يرضى الكثير عن حظِّه في الحياة ويعيش شاكياً متذمراً؟
لماذا أصبحت الشكوى عند الكثير من النَّاس سمةً غالبةً عليهم؟
فمِنَ النَّاس مَنْ تراه في جُلِّ أحواله شاكياً متذمِّراً مما حوله،
لا يعجبه شيء في الحياة،
يشكو إن أصابه خير أو شر، أو كان في غنى أو فقر،
لأنَّه يستطيع أنْ يجد في كلِّ ذلك ما يزعجه ويُكَدِّر خاطرَه،
وينسى في كلِّ أمرٍ الجانبَ المشرق وما يَسُرُّه فيه.
وترى الشَّوكَ في الوُرُودِ، وتَعْمَى..... أنْ تَرَى فَوقَهَا النَّدَى إكليلا
ومثل هذا الصنف لا يحبُّ النَّاس الاستماع إلى حديثه،
فالنَّاس عندهم من الهموم ما يكفيهم وليسوا بحاجة إلى أن يسمعوا ما يزيدهم.
كَفَاكَ مِنَ الشَّكْوَى إلى النَّاس أنَّهُ..... تسرُّ عَدُوَّاً أو تَسُوءُ صَدِيقَا
وقال الشيخ عمر السهروردي:
ويمنعني الشَّكوى إلى النَّاس أنَّني..... عليلٌ ومَنْ أشكو إليه عليلُ
ويمنعني الشَّكوى إلى الله أنَّهُ..... عليمٌ بما أشكوه قبلَ أقولُ
تجد مَنْ متَّعه الله بالصحة والعافية، أو من يملك الأموال الكثيرة،
عابس الوجه لا يبتسم إلا إذا فعل ذلك مخطئاً، وسرعان ما يعود إلى صوابه ويتذكر همومه ويشكوها للناس.
فما هو السبب في ذلك؟
إنه قصور النظر، وقلة المعرفة بحكمة الله من خلقه وتدبيره لشؤونهم،
وعدم الرضا عن الله، والشُّكر له.
ويوشك مَنْ هذا حالُه أنْ تزولَ عنه النِّعَم،
قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}
وقال: {وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ}
قال الشيخ ابن عطاء الله:
«مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النعمَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَوَالِها، وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ قَيَّدَهَا بِعِقَالِها»
وقال الحكماء:
«الشُّكرُ قَيْدُ الموجود، وصَيْدُ المفقود». وقبل هذا وذاك رضا الواحد المعبود.
وقال الإمام الغزالي:
الشُّكرُ قَيْدُ النِّعَم به تدوم وتبقى، وبتركه تزول وتتحول،
قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}،
وقال: {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}.
نظر الفضيل إلى رجل يشكو إلى رجل،
فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك.
وإذا اعْتَرَتْكَ بليةٌ فاصبرْ لها... صبرَ الكريمِ فإنَّه بكَ أعلمُ
وإذا شكوتَ إلى ابن آدمَ إنَّما... تشكو الرَّحيمَ إلى الذي لا يرحمُ
ولو نظر هذا الشاكي إلى حاله لوجد نفسَهُ غارقاً في نِعَمٍ عظيمة،
لا يستطيع شكرها لو بقي طوال حياته ساجداً شكراً لله تعالى،
فلماذا ينسى هذه النِّعَم التي لا تُعَدُّ ولا تحصى
ويذكر بعض المصائب التي لا تُذكر بجانب ما أكرمه الله من فضله.
وإنَّ أعظمَ نعمة هي نعمة الإسلام، والله بفضله ورحمته جعلَكَ مِنَ المسلمين،
و«كفى من جزائه إيَّاك على الطاعة أنْ رضيك لها أهلاً»،
و«كفى العاملينَ جزاءً ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته،
وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته» ،
فيا مَنْ يشكو هل تريد أنْ يكون عندك كلُّ ما تريد مِنَ الدُّنيا
وأنت على غير دين الإسلام؟
إنَّ الإسلام هو الذي يجعلك خالداً في جنة فيها ما لا عينٌ رأت،
ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر،
الجنة التي إذا غُمِسَ فيها أشدُّ النَّاس بؤساً وبلاءً في الدُّنيا ينسى كلَّ شدَّة وشقاء
ويقول لربِّه: (مَا مَرَّ بِى بُؤُسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)،
ومَنْ لم يمت على الإسلام فمصيره جهنَّمُ خالداً فيها-أعاذنا الله من ذلك-.
ألا يستحي الإنسان من ربِّه أنْ يكونَ ديدنُهُ الشكوى إلى المخلوقين،
وهو عاجز عن شكر ما وهبه الله له.
وهَبْ أنَّ ملكاً أعطى رجلاً مِنَ الخير والمال الكثير،
وأغدق عليه في العطاء، وكفاه ما أهمه،
ومع ذلك ترى هذا الرجل متناسياً لما أعطاه الملك،
متكرِّهاً مما حوله،
ألا يُعَدُّ هذا مِنْ لؤم النفس وخستها،
فكيف مَنْ يكون هذا حاله مع الخالق الرازق المنعم المتفضِّل.
أيها الشاكي!
تريد من الله أن يرضى عنك، وأنت لم ترضَ بقضائه وقدره؟
إنَّ الجزاء من جنس العمل،
فإنْ كنتَ راضياً بالله وحُكْمه وتدبيره، فإنَّ الله راضٍ عنك،
وإن كنتَ ساخطاً متذمراً فالله أولى أن يسخط عليك،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(فمن رضي فله الرِّضا، ومن سخط فله السخط) .
ومِنْ فضل الله وكرمه على عباده أنَّه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب،
ولا يضيع منهم شيئاً حتى الصبر على الشوكة يشاكها،
وهذا يكفي لأنْ يشكرَ العبد ربَّه حتى على ما يراه في نظره مصيبة،
فهي عند الصبر والاحتساب عليها، خرجت عن كونها مصيبة إلى نعمة ومنحة
تستوجب الشكر عليها وصارت في ميزان حسناته،
قال صلى الله عليه وسلم:
(عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ،
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ) .
قال إمام الحرمين:
وشدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها،
لأنَّ تلك الشدائد نِعَمٌ بالحقيقة لأنَّها تعرضه لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة.
فعلى المؤمن أنْ يشكرَ الله ويحمده في كلِّ حال،
قال الإمام ابن القيم:
ومقام الشُّكر جامع لجميع مقامات الإيمان ولذلك كان أرفعها وأعلاها،
وهو فوق الرِّضا وهو يتضمن الصَّبر من غير عكس،
ويتضمن التوكُّل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء
فجميع المقامات مندرجة فيه،
لا يستحقُّ صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له،
ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر ونصف شكر،
والصبر داخل في الشكر،
فرجع الإيمان كلُّه شكراً،
والشاكرون هم أقلُّ العباد
كما قال تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} .
فالمؤمن يحمد الله على كل حال،
كما قال ابن ناصر الدين الدمشقي:
يجري القضاءُ وفيه الخيرُ نافلة..... لمؤمنٍ واثقٍ باللهِ لا لاهي
إنْ جاءَه فرحٌ أو نابه ترحٌ..... في الحالتين يقولُ: الحمدُ للهِ
فإن أردتَ السَّعادة والسُّرور، والفرح والفلاح والحبور،
والرَّوْح والنعيم الذي ليس فوقه نعيم،
فعليك بالإيمان بالله حقاً، والرِّضا والتسليم لأمره وحكمه وتدبيره،
الإيمان الذي وَصَفَ نعيمَهُ مَنْ يتحلى به فقال:
«لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف»،
وقال آخر: مساكين أهل الدُّنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها،
قيل: وما أطيب ما فيها؟
قال: «محبة الله ومعرفته وذكره»،
وقال آخر: «إنَّه لتمرُّ بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً»،
وقال آخر: «إنَّه لتمرُّ بي أوقات أقول:
إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيِّب».
وهو النعيم الذي يشبه نعيم أهل الجنة،
قال بعض العلماء:
ليس في الدُّنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة.
قال الإمام ابن القيم:
والله تعالى إنَّما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحاً،
كما قال تعالى:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}.
فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح
الجزاء في الدُّنيا بالحياة الطيبة، والحسنى يوم القيامة،
فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين،
ونظير هذا قوله تعالى:
{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ }،
ونظيرها قوله تعالى:
{وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ}،
ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدُّنيا والآخرة
وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين،
فإن طيب النفس وسرور القلب، وفرحه ولذته، وابتهاجه وطمأنينته،
وانشراحه ونوره، وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة، والشبهات الباطلة،
هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه.
ولا تظنَّ أنَّ قوله تعالى:
{إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}
مختصٌّ بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دُورهم الثلاثة،
وهؤلاء في جحيم في دُورهم الثلاثة،
وأي لذة ونعيم في الدُّنيا أطيب من برِّ القلب، وسلامة الصدر،
ومعرفة الربِّ تبارك وتعالى ومحبَّته، والعمل على موافقته؟
وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟.
فهذه هي السَّعادة الحقيقية التي كلَّما ازداد المؤمن منها ازدادَتْ سعادتُه،
وكلَّما ابتعد عنها نقصتْ سعادتُه بقدر ابتعاده عنها.
فمَنْ شعر بضيق أو همٍّ أو غَمٍّ فليتعهد إيمانه ويراجع يقينه بالله حتى يذهب عنه ما يجد.







 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس



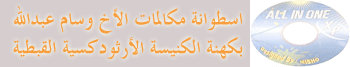



المفضلات