هل الإسلام فكر بدويّ قَبَليّ كما تردّد الببغاوات؟
د. إبراهيم عوضنسمع هذه الأيام من بين المنتسبين إلى الإسلام من يعملون على التنقص من هذا الدين العظيم من خلال اتهامه بأنه فكر قبلى بدوى متخلف، على أساس أنه ظهر في بلاد العرب ذات المجتمعات التى تغلب عليها القبلية والبداوة. وبعض الذين يسمعون هذا الكلام قد يصدقونه، فليس كل الناس عندهم الوقت للتحرى والتقصى ولا النظرة الناقدة التى تمحص ما تسمعه، وبخاصة إذا كان ظاهر الأمر يمكن أن يوحى للمتعجلين بصحة ما يقال، وعلى وجه أخص إذا جاء هذا الزعم في مثل ظروفنا الحالية التى لا تخفى على أحد والتى وصل فيها حال المسلمين إلى درك غير مسبوق لا على المستوى العسكرى والسياسى فقط، بل على المستوى النفسى والفكرى أيضا، إذ لم يظهر فيهم مِنْ قَبْلُ مِثْلُ هذا العدد الكبير الذى يتبع كل ناعق من مبغضى الإسلام دون فهم أو وعى بما يُدَبَّر خلف الستار. إنها عملية انتحار حضاري يجمع بين الغباء والإجرام تقوم بها فئة مارقة تريد أن تجرّ معها بقية الأمة لحساب الأعداء الذين يعملون منذ قرون على تدميرنا وتركيعنا وقطعوا في ذلك أشواطا، وما زالوا مستمرين في عملية التدمير والتركيع دون كلل أوملل ودون أن يراعوا عهدا أو ذمة.
وبادئ ذي بدء نقول إن محمدا -عليه الصلاة والسلام- لم يكن بدويا بأى حال من الأحوال، إذ كان من أهل مكة، فهو إذن حضري لا بدوي، وإن كان هذا لا يعنى التنقص من المجتمعات البدوية بأى معنى، فهى طراز اجتماعى مَثَله مَثَل طراز المجتمعات الريفية وطراز مجتمعات المدينة وطراز حياة الغابة وطراز حياة الإسكيمو... إلخ. ولا يستطيع عاقل أن ينكر التنوع البيئي والاجتماعي الذى تعرفه الكرة الأرضية، فهو سنة كونية لا يمكن تغييرها، كما أنه مظهر من مظاهر الثراء الحضاري. ولكم أمدَّتْ الباديةُ التاريخَ الإنساني بالعظيم من الأفكار والرجال، وكان لها دور لا ينكَر في كثير من عمليات التطور الحضاري. ومن الغباء أن ننظر شزرا إلى المجتمعات البدوية في كل الظروف والأحوال. هذه نقطة مبدئية أحببت أن أُجلِّيها قبل أن أدخل في صميم الموضوع.
والآن نتساءل : إذا كان الإسلام دينا بدويا متخلفا كما تردد الببغاوات التى تقع عقولها في آذانها لا في رؤوسها، فكيف يا ترى استجابت له كل هاتيك الأمم والشعوب التى دخلت ومازالت وستظل تدخل فيه بإذن الله مع اختلاف بيئاتها ونظمها الاجتماعية عن بيئة البداوة، ومنها الأوربيون والأمريكان، فضلا عن العراقيين والمصريين والسوريين والفرس والهنود والصينيين، وهؤلاء أصحاب حضارات عريقة لا كالغربيين الذين لم يعرف معظمهم طعم التحضر إلا بعدهم بأحقاب كما هو معروف لكل من لديه أدنى إلمام بالتاريخ؟ فليفسر لنا الببغاوات إذن، أو بالأحرى فليفسر لنا أسيادهم الذين يجرّونهم من أنوفهم كما تُجَرّ البهائم تلك الظاهرة! ألا إن هذه شِنْشِنَةٌ استشراقيةٌ تبشيريةٌ معروفةٌ لكل من اطَّلع على شيء من القيء الذى تقذف به أفواه الحقد ضد دين رب العالمين. والمستشرقون والمبشرون يعلمون قبل غيرهم أن ما يقولونه في هذا الصدد إنما هو إفك من الصنف التافه الرخيص، لكنهم يعرفون أيضا أن كثرة الطنين به قد يأتي بثمرته بين ذوي العقول القرودية السخيفة والضمائر المنكوسة المهزومة الذين يظهرون بين ظَهْرانَيِ الأمم الضعيفة في أوقات الهزيمة والتحلل، بالضبط كما يظهر الطفح المرضي على الجلد بسبب اختفاء المناعة أو ضعفها. وكيف يفسرون يا ترى استمساك المسلمين -ما عدا هذه القلة المارقة الشاذة- بدينهم رغم أن المغريات بتركه في المرحلة الأخيرة من تاريخهم كثيرة؟
كذلك كيف يشرحون لنا السر في أن هذا الدين قد أنتج حضارة من أبدع وأغنى ما عرفته البشرية من حضارات؟ ولست هنا بسبيل تعداد المنجزات الحضارية التى أبدعها الإسلام في كل الميادين، ولكني أكتفي فقط بالإيماء إلى ما اقتطفته أوروبا من ثمار هذه الحضارة واتخذت منه منطلقا للخروج من وهدة التخلف التى كانت مرتكسة فيها حين كان المسلمون يجسدون المثال الأعلى في المدنية والثقافة على السواء، ثم شرعت تضيف إليه بعد أن رسخت قدمها في مضمار العلم والاختراع حتى صارت إلى ما هى عليه الآن، وأخذت تعمل على ألا يعود المسلمون كما كانوا مدنية وعلما وقوة. أهذا كله إنتاج بدوي قبلي؟ إن كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن القبلية والبدوية شيء عظيم لا يعاب، اللهم إلا ممن في قلوبهم مرض! ويا من تتشدقون بازدراء الإسلام من ببغاواتنا المنكوسة المنحوسة، ها أنتم أولاء تعيشون في مجتمعات حضرية، فما الذى يمنعكم من أن ترتقوا وتقوَوْا وتقضوا على المشاكل التى تعاني منها أممكم وتناطحوا أمم الغرب التي أذاقتكم الويل والهوان؟ لكنكم أعجز وأضأل وأذل وأقل وأضل من أن تستطيعوا ذلك ولا عشره ولا واحدا على المائة ولا الألف ولا حتى المليون منه، رغم الإمكانات الهائلة التى في أيديكم بالمقارنة بما كان متاحا للمسلمين الأوائل مما لم يكن يتعدى الصفر، اللهم إلا قوة العقيدة والإيمان بالله والرسول والقرآن، هذا الإيمان الذى قلّل في أعينهم كل شيء ومكّنهم من صنع ما يُعَدّ اليوم من قبيل المعجزات! إننا الآن مليار ونصف، وتحت أيدينا من الإمكانات ما يحتاج إلى كُتُبٍ وكُتُبٍ وكتبٍ وكتبٍ وكتبٍ لإحصائه، ومع هذا فنحن في ميدان السياسة والإنتاج والقوة الحربية والعلم صفر كبير، أما المسلمون الأوائل الذين خرجوا من الجزيرة العربية، وكانوا في أغلبهم من البدو الذين يظن القرود أنهم قادرون على النيل منهم وتحقير صورتهم وإنجازاتهم الفريدة على مدى الدهر، فكانوا بضع عشرات من الألوف ليس إلا، ومع ذلك استطاعوا أن يفرضوا صوتهم وشخصيتهم على التاريخ ويُنطِقوه بالعربية ويصبغوه بصبغة الله التى ليس مثلها من صبغة... إلى أن أخذت قبضتهم على عروة الدين تتراخى فحدث لهم ما حدث مما نعيش عقابيله الآن هما وغما وخوفا وذلة وتخلفا، بالإضافة إلى السفالة التى يغادينا ويماسينا بها هؤلاء القرود الذين ينتفخون ويشمخون كأنهم سادة، وما هم في واقع الحال إلا عبيد أذلاء لا قيمة لهم بأي معيار من معايير الحضارة والكرامة الإنسانية. ينبغي أن نفرق بين الإسلام الذي هو دين سماوي عالمي للإنسانية جمعاء، وبين المسلمين الأوائل الذين جاء كثير منهم من البادية ثم انضم إليهم أهل الحضر من الشعوب التى دخلت بعد ذلك في دين الله أفواجا وأحبته وخالط منها شغاف القلوب وبذلت في سبيله المُهَج والأموال رخيصة تبتغي بذلك وجه المولى الكريم. ثم تعالَوْا ننظر ما قدمه الغرب المتحضر غير البدوي لنا على مدار عشرات العقود من إذلالٍ واستعمارٍ ونهبٍ لثرواتنا وتدميرٍ لكل طاقاتنا وآمالنا في الانعتاق من الضعف والتخلف ومَلْخٍ لفلسطين الغالية وتقسيمٍ لبلادنا وزرعٍ لعوامل التفرقة بيننا، كل ذلك على نحو مخطط مدروس مُمَنْهَج، إلى جانب القصف اليومى في هذه الأيام النحسات للعراق الحبيب وأرض الإسراء والمعراج المباركة الغالية وأفغانستان المسكينة بكل أسلحة الفتك الرهيبة، وهدم البيوت والمؤسسات وقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ دون أى ذنبٍ جَنَوْه سوى أنهم مسلمون رِخاص لا يستحقون أن ينعموا ببلادهم وثرواتهم، وفى تحدٍٍّ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية مما ضج منه الشرفاء والأحرار من كل أنحاء العالم بما فيها أوربا وأمريكا أنفسهما ولا يزالون!
هذا من ناحية الإطار، فماذا عن المضمون؟
لننظر فيما كان سائدا في بلاد العرب عند ظهور الإسلام من قِيَمٍ وأوضاعٍ ونقارن بينه وبين ما جاء به الرسول الكريم لنرى أهذا الذى جاء به هو من نتاج تلك البيئة أم لا. وبذلك نحسم هذه المسألة بدلا من الاستمرار في الشقشقة بالكلام الذى يمكن أن يطول فيه الجدل إلى ما لا نهاية. وأول شيء نود أن نقف إزاءه هو العقيدة، فما الذى أتى به الرسول في هذا المضمار؟ لقد كان العرب بوجه عام قوما وثنيين، لكل قبيلة أو عدة قبائل صنمها الذى تعبده وتتعصب له، ولا تعرف شيئا عن التوحيد، لكن الإسلام كانت له هنا كلمة أخرى، إذ دعا إلى الوحدانية المطلقة التى لا تشوبها شائبة، فلا أوثان ولا ثنوية ولا تثليث ولا بنوة لله، ولا اقتصار لربوبيته تعالى على أمة معينة يكون هو ربها من دون باقي الأمم كما هو الحال في اليهودية حيث يُنْظَر إليه -سبحانه- على أنه إله بني إسرائيل فحسب، فلا يعرف سواهم ولا يقيم وزنا في رحمته ولا في تشريعاته لغيرهم مهما انحط اليهود وكفروا، ومهما آمن غيرهم وعدل وأحسن واستقام. فالإله في الإسلام هو رب العالمين جميعا، لا لقبيلة أو أمة بعينها، وهو ليس منحصرا في مكان دون مكان، وبابه مفتوح دائما للجميع، ورحمته وسعت كل شيء، وهي سابقة أبدا غضبه، والحسنة عنده بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها فحسب، هذا إن لم يمحها محوا ويسترها على صاحبها كأنه لم يرتكب شيئا. والعبرة عنده بحسن النية والإخلاص وبذل الوسع، وهي أمور في متناول كل إنسان، فلا قرابين ولا مُحْرَقات ولا إيمان بأشياء لا تدخل العقل بل تُعْنِت الضمير وتغرق الإنسان في حيرة وبلبلة وتدفعه لمدابرة المنطق. فأين البدوية والتخلف هنا، وما جاء به الإسلام يتفوق تمام التفوق على كل ما كان معروفا آنذاك وحتى الآن من عقائد وأديان، سواء على مستوى الفكر أو الشعور أو الضمير؟ ليس هذا فحسب، بل إنه يترك الإنسان رغم ذلك لاختياره، فإن شاء آمن، وإن شاء كفر، وحتى لو لم يؤمن فليس العقاب الأخروي بواقع عليه ضربة لازب، إذ إن المجتهد مأجور حتى لو أخطأ، وما دام الحق قد عُمِّىَ عليه ولم يبزغ له نوره رغم بذله الجهد وإخلاصه في رغبة الوصول إليه فإن رحمة الله قريب من عباده المجتهدين المخلصين. كذلك فالعقاب الأخروى لم يكن معروفا عند العرب، اللهم إلا نفرا قليلا لا تأثير له في حياتهم. أما في الإسلام فهناك حساب وثواب وعقاب وجنة ونار، والإنسان ليس كمًّا مهملا في الكون يأتي إلى الدنيا ويموت ثم ينتهي أمره عند هذا الحد كما تنتهي الحيوانات العجماء.
يتبع....







 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

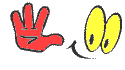




المفضلات