



-
 الرد على دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة الإسلامية
الرد على دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة الإسلامية لتناسبها مع الحضارة الحديثة (*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض المشككين أن القوانين الوضعية أكثر تلاؤما وروح العصر من أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذا فهي أنسب دستور للدولة الحديثة. ويبرهنون على ذلك بكون أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير, في حين أن القوانين الوضعية متغيرة بتغير الزمان، والمكان، والحال.
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في مرونة الشريعة الإسلامية من جهة, ووصم أحكامها بالجمود وعدم صلاحيتها للتطبيق في الواقع المعاصر من جهة أخرى.
وجها إبطال الشبهة:
1) الشريعة الإسلامية ربانية تتسم بالكمال والسمو والديمومة، كما أن بها من السمات المزدوجة كالثبات في مقابل المرونة، والخلود في مقابل التطور ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، والمتأمل لهذه السمة المزدوجة في الشريعة يلحظها على هذا النحو:
· الثبات في الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب.
· الثبات في الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات.
· الثبات في القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية.
وهذا كله بخلاف القانون الوضعي الذي لا يصلح حتى لمن وضعوه.
2) شريعة الإسلام شهد لصلاحيتها الوحي والتاريخ والواقع، في حين أن القانون الوضعي يثبت دائما فشله، مما يقتضي تغييره بين الحين والآخر، ونجاح الشريعة في تحقيق الخير للمجتمع الإسلامي خير دليل على أفضليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
التفصيل:
أولا. بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:
ليس ثمة وجه تقارب بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية يسوغ لأحد الموازنة بينهما فضلا عن الجزم بأفضلية الأخيرة والدعوة إلى استبدالها بتلك؛ فالشريعة أنزلها رب الأرض والسماء، الذي يعلم السر وأخفى، والذي بمقدوره - وحده - أن يهيئ للبشر أسباب الخير والسعادة في حياتهم: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (14)) (الملك).
أما القوانين الوضعية فأنى لها أن تفي بحاجة كل البشر وقد اختلقها بعضهم، فهل نترك ما شرع خالق البشر للبشر ونتحاكم بما شرعه البشر للبشر؟! وتلك القوانين في مجملها عاجزة عن الوفاء بحاجة عصر واحد في بلدان مختلفة، أو بلد واحد في عصور مختلفة.
وهذا أمر بين يقره المنصفون، ويؤيده الواقع, أما ما ادعاه بعضهم من مناسبتها للعصر أكثر من أحكام الشريعة فوهم باطل؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية بها من عوامل القوة والمرونة والسعة والشمولية ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، بخلاف القانون الوضعي الذي لا يصلح حتى لمن وضعوه؛ وما اتهمها بعضهم بالجمود إلا لأن عقولهم عاجزة عن الكمال الرباني المعهود في الشرائع الربانية، على أن الدراسة الموضوعية الجادة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقوانين الوضعية تؤكد تفوق الشريعة الإسلامية وتميزها دائما على ما سواها من الشرائع والقوانين، كما توضح - بما لا يدع مجالا للشك - أن من يفتري القول بأن الشريعة لا تصلح لهذا العصر، وأن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية في الدولة الحديثة المعاصرة، لم تصدر أحكامه تلك عن دراسة علمية موضوعية دقيقة، ولا استندت إلى أدلة منطقية معقولة مقنعة، وهذا ما يوضحه الفقيه عبد القادر عودة - رحمه الله - إذ يقول: "قد تبين من دراسة الشريعة الإسلامية أن القائلين بكونها لا تصلح للعصر الحاضر لا يبنون رأيهم على دراسة علمية أو حجج منطقية؛ لأن الدراسة العلمية والمنطق يقتضيان القول بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولما سيتلوه من عصور.
وفوق هذا فالقائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر الحاضر فريقان: فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون، وفريق درس القانون دون الشريعة, وكلا الفريقين ليس أهلا للحكم على الشريعة؛ لأنهما يجهلان أحكامها جهلا مطبقا، ومن جهل شيئا لا يصلح للحكم عليه.
والواقع أن هؤلاء الجاهلين بالشريعة يبنون عقيدتهم الخاطئة - في عدم صلاحية الشريعة - على قياس خاطئ، وليس عن دراسة منظمة، ذلك أنهم تعلموا أن القوانين الوضعية القائمة الآن لا تمت بصلة إلى القوانين القديمة التي كانت تطبق حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وعلموا أن القوانين الوضعية الحديثة قائمة على نظريات فلسفية واعتبارات اجتماعية وإنسانية لم يكن لها وجود في القوانين القديمة، وتحملهم المقارنة بين هذين النوعين من القوانين على الاعتقاد بعدم صلاحية القوانين القديمة للعصر الحاضر، وهو اعتقاد كله حق، ولكنهم ينساقون بعد ذلك إلى الخطأ حين يقيسون الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية؛ فيقولون: مادامت القوانين التي كانت سائدة حتى أواخر القرن الثامن عشر لا تصلح لعصرنا الحاضر, فكذلك الشريعة الإسلامية التي كانت سائدة في العصور الوسطى، والتي ظل الكثير من أحكامها معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر, وفي هذا القياس الباطل خطؤهم الجسيم الذي لا يكاد يفوت الناقد البصير.
ووجه الخطأ في هذا القياس أنهم سووا بين القوانين الوضعية التي وضعها البشر وبين الشريعة الإسلامية التي تكفل بوضعها خالق البشر، فهم حين يقيسون إنما يقيسون الأرض بالسماء والناس برب الناس، فكيف يستوي في عقل عاقل أن يقيس نفسه بربه وأرضه بسمائه؟
نقول: إن وجه الخطأ في هذا القياس أنهم سووا بين الشريعة والقانون وهما مختلفان في طبيعتهما جد الاختلاف؛ فمعلوم أنه لا قياس بين مختلفين.
وإذا صح أن الشريعة تختلف عن القوانين اختلافات أساسية, وتتميز عنها بمميزات جوهرية فقد امتنع القياس؛ لأن القاعدة أن القياس يقتضي مساواة المقيس بالمقيس عليه، فإذا انعدمت المساواة فلا قياس، أو كان القياس باطلا.
ولما كان القائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر الحاضر يبنون رأيهم على قياس الشريعة بالقوانين الوضعية، ولا مساواة بين الشريعة وهذه القوانين فيكون قياسهم باطلا، وادعائهم بعدم صلاحية الشريعة للعصر الحاضر ادعاء باطلا؛ لأنه بني على قياس باطل، وما قام على الباطل فهو باطل.
وسنعرض فيما يلي نشأة القانون ونشأة الشريعة ووجوه الخلاف بينهما ومميزات كل منهما:
· نشأة القانون:
ينشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها ويحكمها ضئيلا محدود القواعد، ثم تتطور الجماعة فتزداد قواعده، وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت، وكلما تقدمت الجماعة في تفكيرها وعلومها وآدابها.
فالقانون الوضعي كالوليد؛ ينشأ صغيرا ضعيفا، ثم ينمو ويقوى شيئا فشيئا حتى يبلغ أشده، وهو يسرع في التطور والنمو والسمو كلما تطورت الجماعة التي يحكمها وأخذت بحظ من الرقي والسمو، ويبطئ في تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو والتطور؛ فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون الوضعي وتصنعه على الوجه الذي يسد حاجاتها وينظم حياتها، فهو تابع لها، وتقدمه مرتبط بتقدمها.
وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة الأولى له يقولون: إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة والقبيلة، وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة، وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة، وإن القانون ظل يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولة، وإن عادات كل أسرة كانت لا تتفق مع عادات غيرها من الأسر، وتقاليد كل قبيلة لم تكن مماثلة لتقاليد غيرها من القبائل، وإن الدولة حين بدأت تتكون وحدت العادات والتقاليد وجعلت منها قانونا ملزما لجميع الأفراد والأسر والقبائل الداخلين في نطاق الدولة، ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين الدولة الأخرى.
وظل هذا الخلاف حتى بدأت المرحلة الأخيرة من التطور القانوني في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية، فتطور القانون الوضعي منذ ذلك الوقت حتى الآن تطورا عظيما، وأصبح قائما على نظريات لم يكن لها وجود في العهود السابقة، وأساس هذه النظريات الحديثة العدالة والمساواة والإنسانية، وقد أدى شيوع هذه النظريات في العالم إلى توحيد معظم القواعد القانونية في كثير من دول العالم، ولكن بقي لكل دولة قانونها الذي يختلف عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل.
هذه خلاصة لنشأة القانون وتطوره والمراحل التي مر بها, تبين بجلاء أن القانون حين نشأ كان شيئا يختلف كل الاختلاف عن القانون الآن، وأنه ظل يتغير ويتطور حتى وصل إلى شكله الحالي، وأنه لم يصل إلى ما هو عليه الآن إلا بعد تطور طويل بطيء استمر آلاف السنين.
· نشأة الشريعة:
وإذا كانت نشأة القانون الوضعي كما وصفها أهلها - وعلى نحو ما أسلفنا - من التدرج الذي يشبه مراحل نمو الأطفال، فإن الشريعة الإسلامية لم تنشأ ولم تسر في هذا الطريق، ولم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت، ولا نظريات أولية ثم تهذبت, ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية ثم سايرت تطورها ونمت بنموها، وإنما ولدت شابة مكتملة,ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة، جامعة مانعة لا ترى فيها عوجا، ولا تشهد فيها نقصا، أنزلها الله - عز وجل - من سمائه على قلب رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - في فترة قصيرة - لا تجاوز المدة اللازمة لنزولها - بدأت ببعثة الرسول وانتهت بوفاته - صلى الله عليه وسلم - أو انتهت يوم قال الله عز وجل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) (المائدة: 3).
ولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة، أو لقوم دون قوم، أو لدولة دون دولة، وإنما جاءت للناس كافة من عرب وعجم، شرقيين وغربيين، على اختلاف مشاربهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم، فهي شريعة كل أسرة وشريعة كل قبيلة، وشريعة كل جماعة، وشريعة كل دولة، بل هي الشريعة العالمية التي استطاع علماء القانون الوضعي أن يتخيلوها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها.
وقد جاءت الشريعة كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظيم شئون الحكم والإدارة والسياسة، وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة، كما تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم.
ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلي جدتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية؛ فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل، كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل.
وأساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن الشريعة من عند الله - عز وجل - وهو القائل: (لا تبديل لكلمات الله) (يونس: 64)، وهو عالم الغيب القادر على أن يضع للناس نصوصا تبقى صالحة على مر الزمان. أما القوانين فمن وضع البشر، وتوضع بقدر ما يسد حاجتهم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص القانونية التي يضعونها قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه.
ولقد جاءت الشريعة من يوم نزولها بأحدث النظريات التي وصل إليها أخيرا القانون مع أن القانون أقدم من الشريعة، بل جاءت الشريعة من يوم نزولها بأكثر مما وصل إليه القانون الوضعي، وحسبنا أن نعرف أن كل ما يتمناه رجال القانون اليوم - أن يتحقق من المبادئ - موجود في الشريعة من يوم نزولها.
مما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية تختلف عن القوانين الوضعية اختلافا أساسيا من ثلاثة وجوه هي:
1. أن القانون من صنع البشر، أما الشريعة فمن عند الله، وكل من الشريعة والقانون يتمثل فيهما بجلاء صفات صانعه؛ فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم،[1] ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير والتبديل أو ما نسميه التطور كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو وجدت حالات لم تكن منتظرة، فالقانون ناقص دائما ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان.
أما الشريعة: فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هو كائن؛ ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال حيث أحاط علمه بكل شيء، وأمر الله - عز وجل - لا يتغير ولا يتبدل، وهو القائل: (لا تبديل لكلمات الله) (يونس: 64)، وشريعة الله وأحكامه إنما جاءت على هذا النحو من الديمومة والثبات؛ لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الإنسان.
وقد يصعب على بعض الناس أن يؤمنوا بهذا القول؛ لأنهم لا يؤمنون قبل كل شيء بأن الشريعة من عند الله، ولست أهتم - والكلام لعبد القادر عودة - من أمر هؤلاء إلا بأن يؤمنوا بأن الشريعة تتوفر فيها الصفات التي ذكرتها، وعلى أن أقيم لهم الدليل على توافرها وعليهم هم بعد ذلك أن يبحثوا إن شاءوا عن سبب توفر هذه الصفات في الشريعة دون غيرها، وأن يبحثوا عن صانعها، ولعل في إحالة هؤلاء إلى نظريات الشريعة في المساواة والحرية والشورى وسلطة الحاكم والإثبات والتعاقد والدين ما يبطل الزعم ويقيم الدليل؛ ففي تلك النظريات الدستورية والاجتماعية والإدارية والمدنية ما تغني الإشارة إليه عن تفصيله[2]، شريطة أن يتجرد القارئ من هؤلاء من أية خلفية سابقة ويتحرى الدقة والإنصاف والموضوعية!
أما الذين يؤمنون بأن الشريعة من عند الله فليس يصعب عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات التي ذكرناها في الشريعة ولو لم يقدم لهم الدليل المادي على ذلك؛ لأن منطقهم يقضي عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات؛ فمن كان يؤمن بأن الله خلق السموات والأرض، وسير الشمس والقمر والنجوم، وسخر الجبال والرياح والماء، وأنبت النبات، وصور الأجنة في بطون أمهاتها، وجعل لكل مخلوق خلقه من حيوان ونبات وجماد نظاما دائما لا يخرج عليه، ولا يحتاج لتغيير ولا تبديل ولا تطور. من كان يؤمن بأن الله وضع قوانين ثابتة تحكم طبائع الأشياء وحركاتها واتصالاتها، وأن هذه القوانين الطبيعية بلغت من الروعة والكمال ما لا يستطيع أن يتصوره الإنسان.
من كان يؤمن بهذا كله وبأن الله أتقن كل شئ خلقه، فأولى به أن يؤمن بأن الله وضع الشريعة الإسلامية قانونا ثابتا كاملا لتنظيم الأفراد والجماعات والدول، لتحكم معاملاتهم، وأن الشريعة بلغت من الروعة والكمال حدا يعجز عن تصوره الإنسان.
2. أن القانون هو قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شئونها وسد حاجاتها, فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غدا؛ لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة.
أما الشريعة فقواعد وضعها الله - عز وجل ــ على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة، ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل, وهذه الميزة التي تتميز بها الشريعة تقتضي من الوجهة المنطقية:
· أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم؛ بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان، وتطورت الجماعة، وتعددت الحاجات وتنوعت.
· أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع؛ بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر ما عن مستوى الجماعة.
والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة، بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع الأخرى، فقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو.
ولقد مر على الشريعة الإسلامية أكثر من أربعة عشر قرنا تغيرت خلالها الأوضاع أكثر من مرة، وتطورت الأفكار والآراء تطورا كبيرا، واستحدث من العلوم والمخترعات ما لم يكن يخطر على خيال إنسان، وتغيرت قواعد القوانين الوضعية التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة، وعلى الرغم من هذا كله ظلت قواعد الشريعة ونصوصها - التي لا تقبل التغيير والتبديل - أسمى من مستوى الجماعات، وأكفل بتنظيم وسد حاجتهم، وأقرب إلى طلائعهم، وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم.
هذه هي شهادة التاريخ الرائعة يقف بها في جانب الشريعة الإسلامية، وليس ثمة ما هو أروع منها إلا شهادة النصوص ومنطقها، وخذ مثلا قول الله عز وجل: (وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون (38)) (الشورى)، أو اقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».[3] فهذان نصان من القرآن والسنة بلغا من العموم والمرونة واليسر ما لا يمكن أن يتصور بعده عموم أو مرونة أو يسر، وهما يقرران الشورى قاعدة للحكم على الوجه الذي لا يضر بالنظام العام، ولا بمصلحة الأفراد أو الجماعة، وبتقرير مبدأ الشورى على هذا الوجه بلغت الشريعة من السمو حده الأقصى الذي لا يتصور أن يصل إليه البشر في يوم من الأيام، إذ عليهم أن يجعلوا أمرهم شورى بينهم بحيث لا يحدث ضرر ولا ضرار، وهيهات أن يتحقق ذلك بين الناس.
ولو تتبعنا نصوص الشريعة لوجدناها على غرار النصين السابقين من العموم والمرونة والسمو، ومن السهل علينا أن نتبين هذه المميزات لأول وهلة في أي نص نستعرضه، فنصوص الشريعة كلها تصلح أمثلة على ما نقول؛ ويكفي أن نسوق للقارئ مثالا آخر قوله عز وجل: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (النحل: 125)، فهذا النص تدل صياغته على أنه بلغ حد العموم والمرونة، أما المبدأ الذي جاء به النص فلم يعرف أن هناك ما هو خير منه، ولا يمكن أن يتصور العقل البشري أن هناك طريقا لأصحاب الدعوات يسلكونها في نشر دعواتهم خيرا من طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.
ويستطيع القارئ أن يقرأ قوله عز وجل: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (فاطر: 18)، وقوله عز وجل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة: 286)، وقوله عز وجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء: 58)، وقوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة: 8)، وقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) (النساء: 135)، يستطيع القارئ أن يستعرض هذه النصوص وغيرها ليرى كيف بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ، وليرى أن المبادئ التي جاءت بها هذه النصوص قد بلغت من السمو ما ليس بعده زيادة لمستزيد، أو خيال لمتخيل.
3. أن الجماعة هي التي تصنع القانون وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم كان القانون متأخرا عن الجماعة وتابعا لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون.
وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده، فإن هذا الأصل قد تعدل في القرن الحالي، وعلى وجه التحديد بعد الحرب العظمى الأولى؛ بحيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة أو أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، وقد كان أسبق الدول إلى الأخذ بهذه الطريقة روسيا الشيوعية، وتركيا العلمانية،[4] ثم تلتهما إيطاليا الفاشيستية وألمانيا النازية، ثم اقتبست بقية الدول هذه الطريقة، فأصبح الغرض اليوم من القانون تنظيم الجماعة، وتوجيهها الوجهات التي يرى أولياء الأمور أنها في صالح الجماعة.
أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من صنع الجماعة، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه.
وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة، إذا الأصل في الشريعة أنها لم توضع لتنظيم شئون الجماعة فقط كما كان الغرض من القانون الوضعي، وإنما المقصود من الشريعة قبل كل شيء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة، وإيجاد الدولة المثالية، والعالم المثالي، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من المبادئ والنظريات ما لم يتهيأ للعالم غير الإسلامي معرفته والوصول إليه إلا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ لهذا العالم الوصول إليه حتى الآن.
ومن أجل هذا تولى الله - عز وجل - وضع الشريعة، وأنزلها على رسوله - صلى الله عليه وسلم - نموذجا من الكمال ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل، ويحملهم على التسامي والتكامل حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل، وقد حققت الشريعة ما أراده لها العليم الخبير، فأدت رسالتها أحسن الأداء، وجعلت من رعاة الإبل سادة للعالم، ومن جهال البادية معلمين وهداة للإنسانية.
ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون الأوائل متمسكين بها، عاملين بأحكامها، تمسك بها المسلمون الأوائل وعملوا بها وهم قلة مستضعفة، يخافون أن يتخطفهم الناس، فإذا هم بعد عشرين سنة سادة العالم وقادة البشر، لا صوت إلا صوتهم، ولا كلمة تعلو كلمتهم، وما أوصلهم لهذا الذي يشبه المعجزات إلا الشريعة الإسلامية التي علمتهم وأدبتهم، ورققت نفوسهم، وهذبت مشاعرهم، وأشعرتهم بالعزة والكرامة، وأخذتهم بالمساواة التامة، والعدالة المطلقة، وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وحرمت عليهم الإثم والعدوان وحررت عقولهم ونفوسهم من نير الجهالات والشهوات، وجعلتهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله.
كان ذلك حال المسلمين وقت تمسكوا بشرعيتهم، فلما تركوها وأهملوا أحكامها تركهم الرقي وأخطأهم التقدم، ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا يعمهون فيها من قبل فعادوا مستضعفين مستعبدين، لا يستطيعون دفع معتد ولا الامتناع من ظالم.
وقد خيل للمسلمين - وهم في غمرتهم هذه - أن تقدم الأوربيين راجع لقوانينهم وأنظمتهم؛ فذهبوا يتلقونها وينسجون على منوالها، ناسين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله»[5]، وقد كان ما قال الفاروق، فلم تزدهم هذه القوانين وتلك الأنظمة الوضعية إلا ضلالا على ضلالهم، وخبالا على خبالهم، وضعفا على ضعفهم، بل جعلتهم أحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
إن الشريعة الإسلامية، وقد جاءت كاملة لا يشوبها نقص، حاملة في طياتها وسائل التقدم والتطور المستمر للمجتمع، هي أصلح الشرائع لعصور التقدم وعصور التأخر على السواء؛ لأنها في كل الأحوال ترمي إلى تكوين الجماعة الصالحة، وتوجيهها دائما للتقدم المستمر والتطور الصالح، ولا تقنع من ذلك بما هو دون الكمال التام.
إن في تاريخ المسلمين آية، وإنه عبرة لمن كان له قلب، وإن فيه الدليل الحاسم على أن الشريعة الإسلامية هي التي خلقت المسلمين من العدم، وجعلتهم أمة فوق الأمم، ودفعتهم إلى الأمام، وسلطتهم على دول العالم، وإن فيه الدليل الحاسم على أن حياة المسلمين وتقدمهم ورقيهم متوقف على تطبيق الشريعة الإسلامية, فالمسلمون من صنع الشريعة؛ كيانهم تابع لكيانها، ووجودهم مرتبط بوجودها، وسلطانهم تابع لسلطانها.
إن القانون الوضعي حين تحول أخيرا عن أصله الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة, إنما أخذ في ذلك بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها، ثم ينظمها، وهكذا انتهى القانون الوضعي على ما بدأت به الشريعة وسبقت إليه من أربعة عشر قرنا، فإذا ما قال علماء القانون الوضعي: إنهم وصلوا لنظرية جديدة قلنا لهم: كلا ولكنكم تسلكون طريق الشريعة وتسيرون في أثرها.
وعلى هذا يمكننا أن نستخلص مما ذكر من الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون أن الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية هي:
· الكمال: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكمال؛ أي بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد.
· السمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالسمو, أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة؛ وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة.
· الدوام: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام؛ أي بالثبات والاستقرار، فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل، ومهما مرت الأعوام وطالت الأزمان تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.
هذه هي المميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية، و هي على تعددها وتباينها ترجع إلى أصل واحد نشأت عنه جميعا بحيث يعتبر كل منها أثرا من آثاره، وهذا هو أن الشريعة الإسلامية من عند الله ومن صنعه، ولولا أن الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام, تلك الصفات التي تتوفر دائما فيما يصنعه الخالق ولا يتوفر شيء منها فيما يصنعه المخلوق[6]. (*) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1406هـ/ 1986م.
[1]. الحيل: جمع حيلة، وهي اسم من الاحتيال، وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه، وهي في الأصل: تصرف يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب استعمالها في الطرق الخفية التي يتوصل بها المرء إلى غرضه، بحيث لا يدرك الناس مقصده إلا بشيء من الذكاء والفطنة.
والمراد بالحيل الممنوعة: هي التصرفات المشروعة في ذاتها إذا أتى بها المرء ليبطل حكما شرعيا؛ كمن يهب ماله قبيل حولان الحول لمن يثق برده إليه؛ فرارا من وجوب الزكاة عليه.
[2]. لمزيد من التفصيل في هذا الشأن ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1406هـ/ 1986م، ج1, ص 25: 62.
[3]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، (2867)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (2341)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (896).
[4]. العلمانية: قيل: إن ترجمتها الصحيحة "اللادينية" أو "الدنيوية"، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة.
[5]. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الإيمان، (1/130). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (51).
[6]. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1406هـ/ 1986م، ج1، ص13: 25 بتصرف.
يُتبع
التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 07-01-2014 الساعة 11:17 PM
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة الشهاب الثاقب. في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
مشاركات: 3
آخر مشاركة: 02-12-2013, 01:37 AM
-
بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 13-06-2012, 01:34 PM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 23-01-2010, 03:20 AM
-
بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-01-2010, 02:00 AM
-
بواسطة دفاع في المنتدى الفقه وأصوله
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 08-07-2008, 05:39 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى










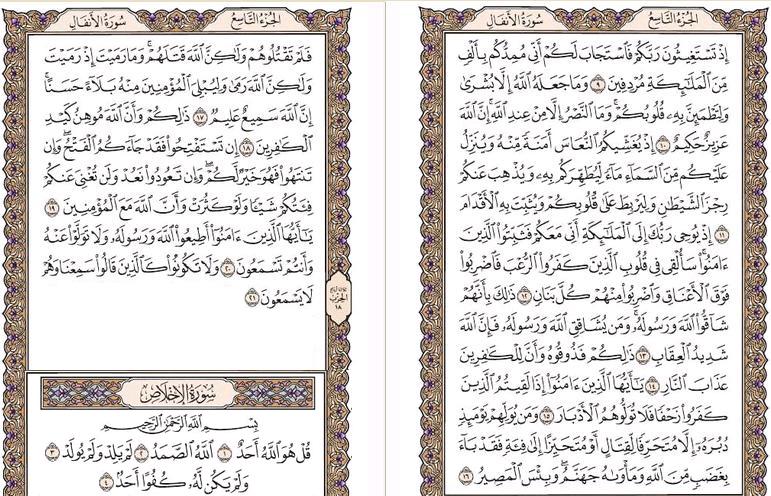



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


المفضلات